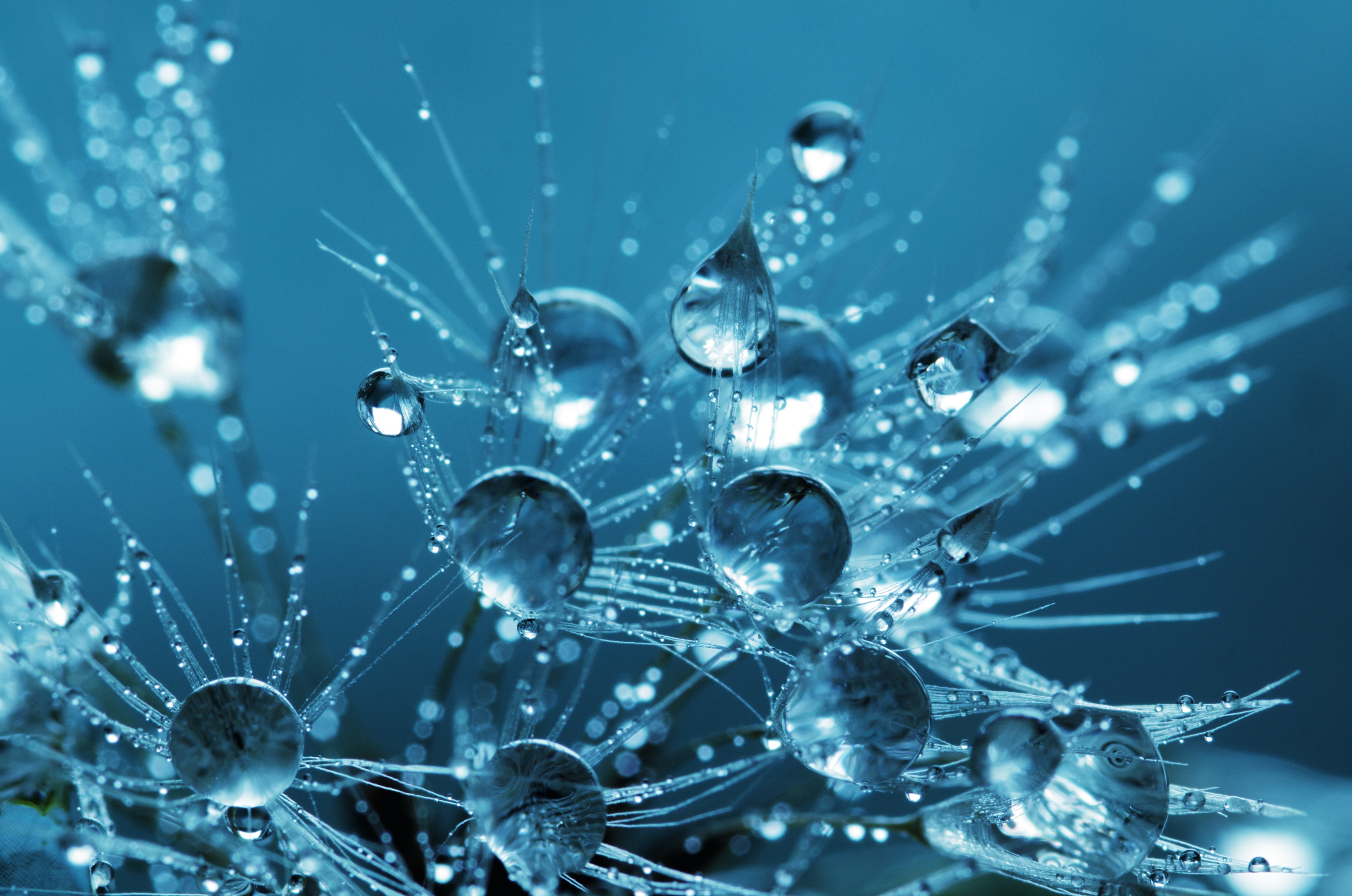Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item
الاعتداءات الالكترونية الواقعة على الامن الداخلي للدولة ودور اجهزة العدالة في مكافحتها
(جامعة النجاح الوطنية, 2025-12-18) Albakri, Aseel
Item
ASSESSMENT OF PUBLIC OPEN SPACE IN PALESTINIAN CITIES AS AN INDICATOR 11.7.1 OF THE SDGS
(جامعة النجاح الوطنية, 2025-11-04) Saleh, Saed
Rapid urban expansion, particularly in Palestinian cities, has led to a severe shortage of open public spaces, adversely affecting the achievement of Sustainable Development Goal 11, which aims to create inclusive, safe, resilient, and sustainable cities. Indicator 11.7.1 provides a key measure of the average per capita share of urban areas allocated to public spaces and streets, serving as a tool to assess progress toward this goal.
This study evaluates the current status of urban public spaces (UPS) in four major cities in the northern West Bank—Nablus, Jenin, Tulkarm, and Qalqilya—considering the rapid urban expansion and the acute shortage of open spaces. The methodology employed Geographic Information Systems (GIS) to delineate urban areas using the United Nations’ Degree of Urbanization (DEGURBA) framework, map public spaces and street networks, and a structured expert survey to assess accessibility.
The results reveal a considerable deficit, with public spaces constituting only 1% of the urban area and streets covering 13.3%, both well below international benchmarks (15–20% for public spaces and 30–35% for streets). Indicator 11.7.1 values ranged from 12.1% in Nablus to 25.2% in Qalqilya. Accessibility analysis in Tulkarm showed that only 52% of residents has adequate access to public spaces, with significant disparities across neighborhoods.
The study concludes that effective planning interventions are necessary, including implementing master plan proposals, revitalizing underutilized areas, and improving pedestrian infrastructure to enhance both the availability and accessibility of public spaces. Additionally, it provides a methodological framework for applying Indicator 11.7.1 in contexts with limited data, offering guidance for sustainable urban planning.
Item
صورة الجسد وعلاقتها بقلق المستقبل ومعايير اختيار شريك الحياة لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في محافظة نابلس
(جامعة النجاح الوطنية, 2026-01-31) هبه زياد رجب شكوكاني
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على العلاقة بين صورة الجسد وقلق المستقبل ومعايير اختيار شريك الحياة لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في محافظة نابلس. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، تكون مجتمعها من طلبة الجامعة، فيما تكونت العينة من (314) طالبًا وطالبة، جُمعت بياناتهم باستخدام ثلاثة مقاييس: مقياس صورة الجسد، مقياس قلق المستقبل، ومقياس معايير اختيار شريك الحياة، بعد التحقق من صدقها وثباتها. وأظهرت النتائج أن مستوى صورة الجسد وقلق المستقبل لدى الطلبة جاء متوسطًا، في حين كانت معايير اختيار شريك الحياة بدرجة عالية. كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط ايجابية ودالة إحصائيًا بين صورة الجسد العلاقة بين قلق المستقبل ومعايير اختيار شريك الحياة. وتشير هذه النتائج إلى أن إدراك صورة الجسد يلعب دورًا مؤثرًا في مستوى القلق حول المستقبل، وفي الوقت نفسه له تأثير محدود ولكنه دال في تحديد معايير اختيار الشريك. أما فيما يتعلق بالمتغيرات الديموغرافية، فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في صورة الجسد وقلق المستقبل تبعًا للجنس أو مكان السكن أو مستوى الدخل، بينما ظهرت فروق في بعض معايير اختيار شريك الحياة تُعزى لمتغير الاناث. وتخلص الدراسة إلى أن صورة الجسد تمثل مؤشرًا مهمًا في الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة، وتؤثر في قرارات مصيرية تتعلق بالمستقبل واختيار الشريك. وبناء على ذلك، أوصت الباحثة بضرورة الاهتمام بالطلبة الذين يعانون من صورة جسد سلبية عبر برامج إرشادية تُعزز من تقدير الذات والرضا عن المظهر الجسدي، إضافة إلى تقديم ورش عمل لتنمية مهارات مواجهة القلق وإدارة الضغوط، وتوجيه الشباب نحو معايير أكثر موضوعية وواقعية في اختيار شريك الحياة.
Item
ENHANCING RESOURCE UTILIZATION IN EDGE COMPUTING USING DEEP Q-NETWORK
(جامعة النجاح الوطنية, 2026-01-18) Yazan Jarrar
This thesis focuses on designing and evaluating machine learning techniques to enhance the scheduling process in an edge computing environment, especially for IoT applications, with the goal of maximizing the number of tasks executed within a specified window limit. Maximizing task completion within deadlines increases throughput and service quality, while missed deadlines can degrade system performance and render results unusable.
This study investigates the two proposed algorithms, Simulated Annealing (SA) and Deep Q Network (DQN), to determine if they outperform the existing solutions for batch task scheduling in an edge computing environment. To validate the results, we used real world Augmented Reality (AR) and Internet of Vehicles data generated by the EdgeCloudSim simulator. The results clearly show that our proposed algorithms outperform others solutions, especially where the resources are strictly constrained.
The results show that our simulated annealing-based algorithm achieved up to a 71% reduction in task failure rate compared with the baseline algorithm when tested in static environments using real IoT and AR data. They also show that our Deep Q-Network based scheduler consistently achieved the lowest failure rates across dynamic scenarios, especially under higher constraints. Moreover, the Deep Q-Network model evaluated in a dynamic environment required substantially less overhead time, under one-third of the simulated annealing algorithm’s runtime, while both algorithms outperformed other baseline algorithms by up to 10% in task failure rate.
These findings support the thesis objective of maximizing the edge resource utilization while ensuring task batches complete within a specified window limit and highlight the efficiency of the Deep Q-Network based scheduling algorithm.
Item
THE IMPACT OF USING EDUCATIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN ENHANCING BASIC MATHEMATICS CONCEPTS AND DEVELOPING MENTAL ARITHMETIC AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
(2025) Ayyad Valia
انطلقت هذه الدراسة بهدف الكشف عن فاعلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التعليمية في تحسين استيعاب المفاهيم الرياضية الأساسية وتنمية مهارات الحساب الذهني لدى طلبة المرحلة الابتدائية في المدارس العربية بإحدى المناطق التعليمية في شمال البلاد، حيث اعتمدت المنهج شبه التجريبي بتصميمه القبلي والبعدي على عينة قصدية مكونة من (40) طالباً وطالبة من طلاب الصف الثاني الابتدائي، وُزعوا بالتساوي على مجموعتين: تجريبية درست باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضابطة درست بالطرق الاعتيادية، وقد استُخدمت في الدراسة أدوات قياس شملت اختباراً للمفاهيم الرياضية، وسلم تقدير لعمليات الحساب الذهني، بالإضافة إلى المقابلات النوعية، حيث أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α≤0.05)لصالح المجموعة التجريبية في جميع المتغيرات، وبحجم أثر مرتفع بلغت قيمة η^2الجزئية له (0.59)، كما أثبتت تحليلات (MANCOVA) تفوقاً مستمراً لمتعلمي المجموعة التجريبية عبر جميع مستويات القدرة، مع فاعلية ملموسة في تقليص الفجوة التحصيلية لدى المتعلمين ذوي التحصيل المتدني، بينما كشف المنظور النوعي والمقابلات والتحليل السلوكي عن تحول جذري في الأداء المعرفي؛ حيث انتقل المتعلمون من الاعتماد على الوسائل الحسية (كالعد بالأصابع) إلى تبني استراتيجيات ذهنية مرنة وعليا كالتجزئة والتعويض، مع تطور ملحوظ في مهارات "ما وراء المعرفة" والدافعية الذاتية نتيجة بيئة التعلم التكيفية التي وفرت تغذية راجعة فورية ومسارات تعلم مخصصة؛ وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تبني استراتيجية وطنية واضحة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكية ضمن مناهج الرياضيات للمرحلة الابتدائية، وتوفير برامج تدريبية تخصصية للمعلمين لتطوير كفاياتهم في توظيف التقنيات الذكية وإدارة بيئات التعلم التكيفية.
الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي التعليمي، المفاهيم الرياضية الأساسية، الحساب الذهني، المرحلة الابتدائية.